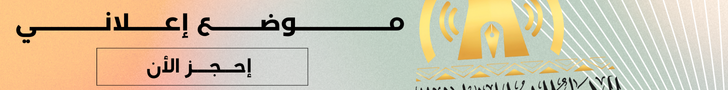انطلقت ثقافة الكناواة في المغرب من عمق المعاناة التي عاشها أفراد وجماعات من أصول إفريقية خلال فترات العبودية وتجارة الرقيق، إذ تعود بدايات هذه الثقافة الشعبية إلى القرن السادس عشر، وشكلت منذ ذلك الوقت أسلوبًا خاصًا في التعبير الفني والروحي والجماعي، حيث دمجت بين الطقوس الصوفية والتقاليد الموسيقية والأداءات الجماعية التي تجمع بين الوظيفة الدينية والمتعة الجمالية.
تشير الكناواة إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة والممارسات التي تشمل الموسيقى الصوفية والطقوس الليلية ومجالس الذكر الجماعي، وتقام هذه الفعاليات غالبًا في أحياء المدن الكبرى من أجل طرد الأرواح الشريرة، بينما تنتشر في المناطق الريفية طقوس الولائم الجماعية المرتبطة بالأولياء، وتعد هذه الطقوس فرصة لإحياء العلاقات الاجتماعية وتعزيز الإحساس بالانتماء المشترك بين أبناء المجتمع المحلي.
تعتمد هذه الثقافة على الأداء الموسيقي الجماعي باستخدام آلات تقليدية كالقراقب والكمبري، ويتميز الأداء بالانسجام الحركي والغنائي الذي يدمج بين الاستغراق الروحي والحركات الجسدية المكثفة، كما ترتبط عروض الكناواة غالبًا بحالة من النشوة الصوفية، حيث يختلط الذكر الديني بالموروث الشعبي الإفريقي، ما يجعلها مزيجًا فنيًا فريدًا يعكس تداخل الثقافات وتفاعلها داخل المجتمع المغربي.

تعمل فرق الكناواة اليوم في إطار جمعيات ثقافية تنشط على المستوى المحلي والوطني، وتشارك هذه المجموعات في تنظيم مهرجانات ومناسبات سنوية داخل المغرب وخارجه، وتشكل هذه الأنشطة منصات لعرض الموروث الشعبي المغربي أمام جمهور واسع، وتسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز مكانتها ضمن المشهد الفني العالمي، وتتميز المدن الكبرى مثل الصويرة ومراكش والدار البيضاء بتعدد الفعاليات الفنية التي تستضيف أبرز المجموعات الموسيقية الكناوية.
أدى إدراج ثقافة الكناواة ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي سنة 2019 إلى زيادة الوعي الدولي بأهميتها، وشكل هذا الاعتراف فرصة لتوثيق هذا الموروث وضمان نقله للأجيال القادمة، كما شجع على دعم الجمعيات المحلية وتمويل مشاريع فنية جديدة، وهو ما ساعد على تطوير الأساليب التدريبية وحماية الطقوس التقليدية من الاندثار.
المصدر: اليونسكو