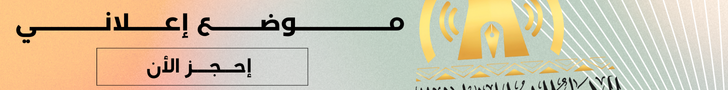بنى البرتغاليون القلعة في مازاغان عام 1514 ميلادية لتعزيز مواقعهم الاستراتيجية على الساحل المغربي، وقاموا بتوسعتها عام 1541 لتعزيز التحصينات، وتتميز القلعة بأسوارها العالية وأبراجها المدروسة التي جعلتها حصناً منيعاً ضد أي هجوم بحري أو بري، كما شكلت قاعدة للسيطرة على التجارة البحرية في المحيط الأطلسي.
أعاد السلطان العلوي محمد الثالث السيطرة على القلعة عام 1769، ليضعها تحت الإدارة المغربية، وبعد سنوات أمر السلطان أبو الفضل عبد الرحمن بن هشام بإعادة بناء الأجزاء المدمرة من القلعة، وأشرف على تشييد مسجد داخلها ليصبح مركزاً اجتماعياً ودينياً للمجتمع المحلي، وتحولت القلعة تدريجياً إلى رمز للتراث المغربي المشترك بين العهد البرتغالي والعهد العلوي.
تستقطب القلعة اليوم زواراً محليين ودوليين نظراً لقيمتها التاريخية والمعمارية، حيث يمكن رؤية الأبراج المدورة والأسوار الطويلة التي تعكس فنون الهندسة العسكرية الأوروبية في القرن السادس عشر، بالإضافة إلى المشاهد البحرية التي تظهر من أسطح القلعة، وتساهم هذه التجربة في التعرف على طرق الدفاع وأساليب البناء المعقدة في تلك الحقبة.

تشكل القلعة جزءاً من مدينة مازاكان البرتغالية القديمة، والتي أدرجت ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2004، تقديراً لقيمتها التاريخية والمعمارية، كما تساهم في الحفاظ على الذاكرة المشتركة بين البرتغاليين والمغاربة، وتعد مثالاً حياً على التبادل الثقافي والحضاري بين أوروبا وشمال إفريقيا، وتبرز دورها كعنصر محوري في فهم تاريخ الساحل المغربي وتأثيرات الاستعمار البرتغالي.
يعكس الموقع تطور استراتيجيات الدفاع والحياة المدنية في المدينة خلال العصور المختلفة، ويتيح دراسة مستفيضة لتصميم القلاع الأوروبية وتكيفها مع البيئة المحلية، كما يوضح التغيرات التي طرأت على استخدام الأبنية بعد الانتقال من السيطرة البرتغالية إلى الإدارة المغربية، ويعكس أثر التحصينات العسكرية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في تلك الفترة.
تستمر القلعة في أداء دورها الثقافي والتعليمي من خلال البرامج السياحية والفعاليات التاريخية التي تنظمها السلطات المحلية، كما تُستخدم كمنصة لورش العمل المتعلقة بالتراث وحفظ المواقع التاريخية، ويُشجع الزوار على استكشاف المعمار والتاريخ بشكل عملي، مما يعزز الوعي بقيمة الحفاظ على التراث، ويؤكد أهمية إدراج مثل هذه المواقع ضمن قوائم التراث العالمي لضمان استمرارها للأجيال القادمة.
المصدر: اليونسكو