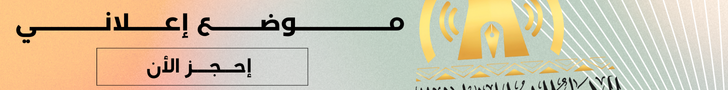بُني مسجد ابن خيرون في مدينة القيروان عام 866 ميلادية على يد محمد ابن خيرون، وقد حمل لاحقًا اسم مسجد الثلاثة أبواب نظرًا لبوابته الأمامية التي تتكون من ثلاث فتحات متجاورة، ما جعله معلمًا مميزًا في العمارة الإسلامية بشمال إفريقيا.
جاء بناء المسجد خلال فترة ازدهار دولة الأغالبة التي شهدت توسعًا في الحركة العمرانية والدينية، وقد جسد تصميمه خصائص الفن الأغلبي من حيث البساطة والزخرفة الهندسية والنقوش الحجرية التي تعلو البوابة وتزين واجهته.
تميز المسجد بحجمه الصغير وواجهته الحجرية المزينة بكتابات كوفية دقيقة ونقوش محفورة، ويعد من أوائل النماذج التي دمجت بين الشكل الوظيفي للمسجد والزينة المعمارية، ما أعطاه قيمة فنية جعلته موضع دراسة في المدارس المعمارية المهتمة بالتراث الإسلامي.
يضم المسجد محرابًا بسيطًا ومنبرًا متواضعًا، وقد خُصص للصلاة اليومية ولم يكن مخصصًا للجمعة، ما يشير إلى انتشاره كمسجد محلي يخدم سكان الحي المجاور، ويعكس نمط المساجد الصغيرة التي انتشرت في المدن الإسلامية خلال القرون الأولى.
رغم صغر حجمه، فإن مسجد ابن خيرون يُعد مرجعًا تاريخيًا في تطور التصميم المعماري للواجهات، خصوصًا استخدام الزخارف الهندسية والخط الكوفي بطريقة وظيفية وزخرفية في آن واحد، مما يجعله سابقًا لعصره مقارنة ببقية المساجد التي ظهرت في المنطقة لاحقًا.
صنفته منظمة اليونسكو ضمن التراث العالمي في عام 1988 ضمن موقع مدينة القيروان، لما يمثله من عنصر معماري يعكس هوية المدينة وتاريخها الثقافي والديني، حيث بقي على حاله تقريبًا دون تغييرات كبيرة رغم مرور أكثر من أحد عشر قرنًا.
تقوم السلطات التونسية منذ سنوات بصيانة المسجد ضمن مشروع حماية تراث القيروان، وتحرص على تنظيفه وترميم نقوشه دون التأثير على طابعه الأصلي، كما تستقبل زيارات ميدانية من طلاب العمارة والمهتمين بالتراث الإسلامي لتوثيق تفاصيله الفريدة.
ما زال المسجد يُستخدم للعبادة، ويعكس استمرار دوره الديني في مجتمع القيروان، كما يمثل رابطًا حيًا بين الماضي والحاضر، ويشهد على تواصل العناية بالتراث المعماري الإسلامي في تونس رغم التغيرات الحضرية والاجتماعية التي شهدتها المدينة.
المصدر: ويكيبيديا